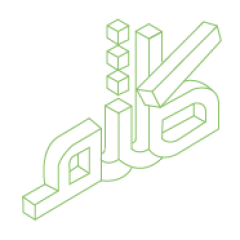في زمن بعيد عن يومي هذا كنت كثيرة التردد إلى مكتبة الجامعة. مازلت أذكر لون المبنى المائل للصفرة، وزواياه المربعة الحادة حيث تختبئ مقاعد منسية حتى من موظفي المكتبة أنفسهم. النوافذ الدائرية الضخمة ونقوشها الهندسية التي تسمح لأشعة الشمس بالدخول بأشكال سداسيّة ملّونة. كانت تشدني الأدراج المهملة لبطاقات الكتب خلف الدرج الملتوي. هل يذكر بطاقات الكتب أحد اليوم؟ ولماذا كان درج المكتبة ملتوياً هكذا؟
كل شيء كان يقفز من ساعة زمنٍ هائلة. في كل مرة أدخل فيها المكتبة أشعر بأن قيامةً سرمديةً ما تحدث هناك. المبنى القديم المتهالك، الكتب القديمة التي يكاد لا يأتيها أحد. كل شيء بدا حيّا هناك، أكثر من العالم في الخارج. في أول مكان أتخذه ملاذاً غير البيت في حياتي.
كنت حينها مولعة بكتب التاريخ والشعر، أجلس على كرسي خمري اللون خلف أرفف قسم التاريخ لا يجلس عليه أحد لأنه في نهاية الجزء الشرقي من المبنى، كما أن أحداً لم يكن يبحث في كتب التاريخ إلا لماماً. كنت أجلس هناك لساعات، لا أسمع صوتاً ولا أرى أحداً. لم أكن من محبي ولا مستخدمي التكنولوجيا حينها، على الرغم من بساطتها مقارنة باليوم. لم يكن العالم متسعاً (على الأقل إلكتورنياً) كما هو الآن. لذلك كنت حرفيّا لا أملك سوى الكتب (ما أجملها من جملة حقيقةً). لم تكن الموبايلات الحديثة موجودة حينها، نوكيا لم يطوّر خاصيّة التصوير إلا بعد تخرجي، ولا أملك مع الأسف أي صورة من ذلك الزمن. لكن الصور تختبئ عندي في أغاني فيروز التي كنت أكتشفها حينها. بمجرد أن تبدأ “سحرتنا البسمات” أو “أهواك” اليوم، تقفز بين ناظريّ أرفف الكتب، ولون الشمس الساعة 1.25 ظهر يوم الاثنين عام 2004، رائحة عطر العنبر لجدتي العالق بملابسي لأنني كنت أشاركها الغرفة (لم نكن نرتدي العباءات السود وقتها داخل الحرم الجامعي)، موعد مسلسل حاتم علي الساعة السادسة مساءاً، وعينا تيم حسن. كيف تختبئ كل هاته التفاصيل في صوت فيروز؟ هل تعلم فيروز ذلك؟ ولماذا كنت أحب أغاني زكي ناصيف لها تحديداً؟ على الرغم من أنني عرفته متأخراً، بعد تخرجي بسنوات. هل كانت صدفة؟
كنت أعشق كتب التراث، الشعراء والبخلاء وقصص الأعراب والجواري والنسّاك والزنادقة. كنت ألتهم الديوان تلو الآخر، ابن خفاجة، ابن زيدون، المتنبي طبعا، أبو العتاهية (كنت مشدودة لفكرة الزهد وقتها)، البحتري، أبو نواس، المعري، ثم الكتب التي تجمع الشعر كجواهر الأدب مثلا. كنت أتصفح كتب العمارة الأندلسية واحفظ أسماء المدن والمباني حتى أزورها في يوم ما. خططت لرحلة اسبانيا كاملة في ذلك الوقت، زرتها بعدها بسنوات عام 2014. كنت أحفظ تريخها كله في زيارتي تلك.
أذكر اليوم الطريف الذي قررت أن أقرأ فيه كتاب ألف ليلة وليلة، لم أكمل القراءة ولم أكن حقيقة مهتمة به لولا الفضول بسبب كل ما سمعته عنه. كانت النسخة غير منقحة، كنت أقرأ الفقرة ثم أُصدم من المكتوب وتحمر وجنتاي ثم اتلفت إن كان يراني أحد. لم يأتِ بعد هذه الصدمة الطريفة إلا صدمة المباشرة في تفاصيل “الخبز الحافي” بعدها بسنوات قليلة. أبتسم اليوم من سذاجتي في ذلك العمر.
لسبب ما كذلك كنت أقرأ للمستشرقين والاستشراق، ومن يرد عليهم. أظن بأنها حزمة تأتي جملة واحدة لتكمل اهتماماتي. خصوصاً بأني كنت أحلم بأن أتخصص في التاريخ، ولم أفعل. لكنني أفعلها اليوم بعد مرور كل هذا الوقت. وكأن تلك الفترة الزمنية هي المخزون الذي أعود إليه، والذي شكّلني من حيث لا أعلم والذي ما يزال يرعاني لليوم.
أذكر هذه الأيام الآن وأعرف بأنها أصفى أيام عمري، كصفاء نور الشمس المتكسر والدافئ من تلك النوافذ. المبنى مايزال موجوداً اليوم إلا أنه تحوّل لمكاتب إدارية. تحول ككل شيء آخر عرفته في هذه المدينة. عُدت إليه مؤخراَ، كان شعور التبلد هو الجاثم على قلبي، كأنني تعودت خذلان المدينة لي، تعودت على عبثها بذاكرتي. كأن أحداث الذاكرة حصلت في حياة موازية، ليست هي الحياة هذه. وعليّ إن أردت العودة للمكان أن أعود لتلك الحياة الموازية. بالأمس قالت لي صديقتي بأنني “سنتيمنتالية جداً”، ربما أكون كذلك حقاً، أم لعله الواقع دفعني لذلك؟
لم أتصور يوماً حين كنت أجلس على ذلك الكرسي الخمري اللون بأنني سأعمل بعدها بسنوات في مكتبة. سأكتب عن تجربتي هذه قريباً، حينما يسعفني ما بقي لي من حياد تجاه تجاربي المهنية.